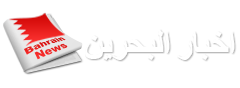إيلاف - 4/3/2025 4:30:33 AM - GMT (+3 )

سوريا والسودان وليبيا واليمن، أربع دول عربية تعيش مخاض الدولة المطلقة. وبيان ذلك: أن أي بلد لا يستطيع العيش في أمان واستقرار، من دون حكومة قوية، سواء كانت عادلة أو جائرة. صحيح أن العدل هو مطلب الناس وغايتهم، لكنه لا يتحقق إلا بوجود حكومة قوية مستقرة. من هنا قال علماء السياسة إن الخطوة الأولى لاستقرار السياسة العادلة، هو وجود دولة قوية مطاعة. فإذا وجدت، حان وقت الانتقال للمرحلة الثانية، أي تنظيم إدارة الدولة على أساس المشاركة العامة للمجتمع في الحقوق والتكاليف.
يبدو لي أن معظم الدول النامية، وقعت أسيرة الخلط بين المرحلتين، فبعضها تجمّد عند الأولى، وبعضها انخرط في جدل مبكر حول المرحلة الثانية، بحيث بدا للمواطنين وأطراف المشهد السياسي أن الاتفاق على الخطوة الأولى مشروط باتفاق مسبق على تفاصيل الثانية. دعنا نأخذ مثلاً من ليبيا، حيث اتفقت القوى السياسية مرات عديدة على عقد انتخابات عامة لاختيار رئيس الدولة، مع أنهم لم يقيموا الحكومة الواحدة التي تبسط سلطانها على أرض البلاد أقصاها وأدناها.
ربما ظن الوسطاء الذين سعوا لحل الأزمة الليبية أن انتخاب الرئيس سيوفر فرصة للإجماع على التمثيل السياسي للبلد. وهو ظن في غير محله. ولو حصل فسوف يكون الرئيس مجرد وسيط وطني، يضاف إلى الوسطاء الدوليين، ولن يكون حاكماً بالمعنى الذي نعرفه عن رئيس الدولة. السبب ببساطة هو أن مصادر قوة الدولة، ولا سيما الأموال والقوات المسلحة، في يد أطراف سياسية متنازعة، لأن الدولة المركزية غير موجودة في الأصل. على أي حال فحتى هذه الخطوة الرمزية لم يكتب لها النجاح، فلم تعقد الانتخابات ولا انتُخب الرئيس. وبقيت البلاد، كما كانت منذ 2014، مقسومة بين حكومتين؛ تسيطر إحداهما على بعض الشرق والأخرى على بعض الغرب.
قيام الدولة الواحدة القوية ضروري للتطور السياسي. ومن دونه ستعود البلاد إلى فوضى ما قبل الدولة، كالذي نشهده اليوم في البلدان المذكورة.
حسناً. لماذا لا تبادر الأطراف السياسية للاتفاق على معالم المرحلة الثانية، وتضعها كمسودة إعلان دستوري، ثم تتفق على إقامة السلطة الواحدة القوية؟
الجواب معلوم: كل طرف لا يطمئن للآخر، بل يخاف أن يقع في قبضته فيخسر حقوقه، أو يخسر فرصته في أن يكون حاكماً أو شريكاً في الحكم.
لعلكم الآن تقولون إن هذه هي أيضاً مشكلة السودان واليمن وسوريا. لماذا انفصل جنوب السودان عن شماله في 2011؟ لأن الرئيس السابق عمر البشير أبى أن ينتقل بالنظام السياسي من حكم الفرد إلى المشاركة السياسية الفاعلة، فضحى بوحدة البلد، كي لا يخسر سلطانه. وحدث الأمر نفسه في اليمن عام 1994، وحدث شيء قريب من هذا في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، حين أبى الرئيس السابق أن يشرك معارضيه في السلطة، فقاد البلد إلى أزمتها الحالية، وكان في وسعه أن يبرز كمصلح تاريخي، كما يأمل كثير من الناس.
في ظني أن جذر المشكلة، في كل هذه البلدان، هو أن الذين بيدهم مصادر القوة، خاصة أصحاب السلطة والسلاح، لا يؤمنون بأن جميع المواطنين شركاء في سياسة بلدهم، شراكة جذرها امتلاكهم تراب الوطن، وأن هذه الشراكة مصدر لحق المواطنين في شراكة مماثلة في الشأن العام. بعبارة أخرى فهم لا يؤمنون بتساوي جميع أهل البلد في الحقوق والواجبات، بناءً على كونهم ملاكاً لوطنهم، وأنهم – لهذا السبب أيضاً – مكلفون بحمايته وتنميته وتطوير إنجازاته. وفي السياق نفسه، فإن الغالبية الساحقة من المواطنين، لا يرون أنفسهم معنيين بالشأن العام، أو ما يسمى في الثقافة العربية الدارجة «التدخل في السياسة».
الشراكة المتساوية بين المواطنين، هي القاعدة الأولى لما يعرف في علم السياسة بالإجماع الوطني. والإيمان بها هو الأساس لكل مجتمع سياسي حديث. ولنا عودة إلى الموضوع في قادم الأيام.
إقرأ المزيد